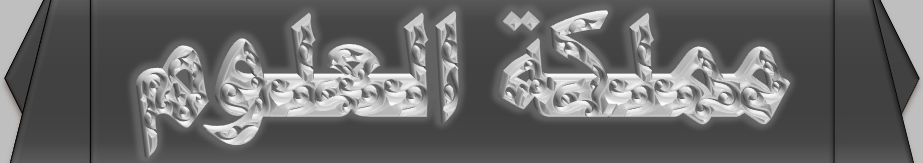سنتحدث هنا عن ثلاث نظريات بدلت رؤيتنا للكون هي
النسبيةونظرية الكم والانفجار الكبير.
النسبية
في روما وفي العام، 1663، حكمت الكنيسة على الفيزيائي غليليه، بالإقامة الجبرية، لمدى الحياة. أما الجريمة فهي تأكيده بأن الأرض كروية، وتدور حول الشمس.
رغم هذا الحكم عليه، غيرت نظرية غليليه من نظرتنا إلى الكون. بعد أربعة قرون، قام فيزيائي آخر، بطرح الفكرة ذاتها.
من كان ليصدق بان أحد أهم علماء الثورة العلمية عبر الأزمنة، كان موظفا بسيطا في مكتب تسجيل الامتيازات؟
ولكنها الحقيقة، ففي عام 1905 حين كان في السادسة والعشرين من عمره، طور ألبيرت أينشتين نظرية علمية أصابت المجتمع الإنساني بالحيرة. عرفت بنظرية النسبية.
لم يأت محتوى النظرية من أينشتين بل جاء أولا على لسان عالم الفلك والفيزياء والرياضيات الإيطالي غليليه، المولود في بيسا عام 1564.
قبل غليليه كان الاعتقاد السائد يقول أن لكل شيء، كالمركب مثلا، حالة وجود طبيعية واحدة. هي السكينة.
أما الحركة فكانت تعتبر مسألة مختلفة وخارجة عن الطبيعة.
وصف غليليه ذلك بالخطأ وكتب يقول انه لولا اعتماد الراكب على أي نقطة إشارة خارجية لما كان بوسعه التأكد مما إذا كان المركب يتحرك أم لا. لنفترض مثلا أن الراكب رمى بكرة ما، لو كان المركب ساكنا، لسقطت الكرة باتجاه مباشر.
عندما يتحرك المركب بسرعة ثابتة يستمر الأمر على حاله. فبالنسبة للراكب ستسقط الكرة عموديا باستمرار. كان السبب في هذه الظاهرة بسيطا بالنسبة لغليليه. فالقانون الفيزيائي الذي يتحكم بحركة الأشياء هو نفسه، سواء كنا نتحرك أم لا. الحركة والسكينة باختصار ليستا مسألة مطلقه بل تحكمها النسبية.
حين ظهر اينشتين على الساحة مع بداية القرن العشرين، كانت كل الأشياء تواكب النظرية النسبية سالفة الذكر. فمع أن الكرة الأرضية تدور بسرعة 11 كيلومترا في الثانية، يشعر المرء وكأن الأرض ساكنة.
هذا ما يوضح السبب الذي يمكن الأولاد من اللعب بالكرة دون أن تحط على بعد آلاف الأميال.
هناك لسوء الحظ شواذ عن هذه القاعدة، وذلك في حركة الضوء.
كان الاعتقاد السائد أيام أينشتين يقول أن موجات الضوء تتحرك دائما بالسرعة ذاتها أيا كانت نقطة مراقبتها.
وقد شعر أينشتين أن هذا يتناقض مع مبدأ النسبية. لنستقل قطارا هذه المرة، ينطلق بسرعة مائة كيلومتر في الساعة. ونتخيل مسافرا في مؤخرة القطار يسير نحو المقدمة بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة.
سيرى مراقب المحطة الجالس خارج القطار، أن المسافر لا يمشي بسرعة خمسة كيلومترات بل بسرعة مائة وخمسة كيلومترات في الساعة.
يؤكد ذلك مبدأ النسبية حيث أن سرعة المسافر تعتمد على سرعة القطار.
لسوء الحظ، لا يمكن تطبيق هذه النظرية البسيطة، على يتعلق بأمور الضوء. فالمسافر الذي في مؤخرة القطار هذه المرة، يرسل ومضة بريق نحو الأمام، باستعمال إنارة فلاش.
بالنسبة للمسافر، سينطلق النور من الفلاش بسرعة الضوء العادية. وهي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية.
أما بالنسبة للمراقب في المحطة، فمن المفترض أن تضاف سرعة الضوء إلى سرعة القطار. ولكن هذا ليس ممكنا.
فالضوء يسافر بالسرعة نفسها أينما كان من يراقبه.
لمواجهة هذا التناقض الغريب، توصل أينشتين إلى ما قد يبدو أيضا فكرة غريبة. فقال إذا ما كانت سرعة الضوء ثابتة، فالوقت من جهة أخرى مطاطي.
بعبارة أخرى الوقت لا يسافر بالسرعة نفسها بالنسبة للمراقب الثابت أو المراقب المتحرك.
وقد أثبتت التجربة التالية ذلك. وقف المسافر في العربة الوسطى، ثم وجه وسيلتي إضاءة في وقت واحد.
إحداهما نحو مقدمة القطار، والثانية نحو الخلف. حين تصل ومضة الضوء إلى نهاية العربة، تؤدي إلى فتح الباب في كلا الاتجاهين. بالنسبة للراكب، سيفتح البابين بوقت واحد. لان ومضة الضوء ستصل إلى الجانبين بوقت واحد.
أما بالنسبة للمراقب الذي يجلس في المحطة، فلم يفتح البابين بوقت واحد.
يبدو أن نهاية القطار تسير نحو لقاء ومضة الضوء. في حين تهرب الومضة الأمامية منها: أما النتيجة، فهي أن الضوء يصل إلى الباب الخلفي أولا، ليليه الباب الأمامي. لهذا السبب سيفتح الباب الخلفي، قبل الباب الأمامي.
هذه التجربة التي سماها اينشتين، تجربة محسوبة. تؤكد أن الوقت ليس مسألة مطلقه، كما كان يعتقد سابقا، بل نسبيه، وحركته تعتمد على حركة الشخص الذي يقيسه.
إلا أن تأثير النسبية يمكن ملاحظته بسرعة قريبة من سرعة الضوء.
كما توقع اينشتين أن انطلاق السفن الفضائية بهذه السرعة، سيجعل الوقت يسير ببطء اكبر منه على سطح الأرض.
هذه مفارقة التوأمين. تخيل أن أحدهما يسافر على متن سفينة فضائية بسرعة الضوء تقريبا، في حين يبقى التوأم الآخر على الأرض، ما يعني أن الأخير سيهرم بسرعة اكبر.
ولكن اينشتين أكد بأن شيئا لن يسافر بسرعة اكبر من سرعة الضوء. حتى أن شيئا لا يمكنه معادلة سرعة الضوء. لان كتلته ستصل إلى ما لا نهاية، وسيطلب كمية كبيرة من الطاقة، ليصل إلى هناك.
سواء كان ذلك سيعجب هواة علم الخيال أم لا، فقد تم تحديد السرعة القصوى، بسرعة الضوء.
نظرية النسبية، لا تحمل أجوبة على كل الأسئلة.
فهي غير صالحة لشرح ما يحدث ضمن ما هو أصغر حجما، كما في الذرة مثلا. للإجابة على ذلك، يجب أن نلجأ إلى نظرية الكم.
نظرية الكم
هناك نوعين من الظواهر في عالمنا هما: الضوء والمادة. ولكن مما يتألفان تحديدا ؟
كان لا بد من الإجابة على هذا السؤال في القرن العشرين، ليبدأ العلماء في تشييد نظرية الكم.
حتى حينها قسم الفيزيائيون الظواهر الطبيعية إلى جزأين هما: الأمواج والذرات.
الذرات، كالصخرة مثلا، هي جسم قائم في الفضاء. ومن السهل تحديد موقعه. أما الموجة فتنشأ عندما نقذف بالصخرة إلى الماء، لتسير الأمواج في جميع الاتجاهات ضمن حركة مستمرة لا يمكن تحديدها.
في بداية القرن الحالي ساد اعتقاد بأن الضوء يتألف من موجات.
والحقيقة أن كل لون من أشعة الضوء توحي بتوافقها مع موجة مختلفة الطول. فموجة الضوء الأحمر تبدو أطول بضعفي موجة الضوء الأزرق.
أما الذرات بالمقابل، وهي صورة مصغرة عن المادة، كانت تعتبر جزيئات، فهي نفسها مؤلفة من جزيئات اصغر. تقسم إلى نواة تدور في فلكها عدة إلكترونات أو إلكترون واحد على الأقل.
إلا أن ملاحظة بسيطة تتحدى هذه النماذج. فإذا ما تم تسخين قالب من الحديد مثلا، وفق الفيزياء الكلاسيكية، لا بد أن تنبعث منه موجات ضوئية من كل الأحجام.
إلا أن هذا ليس ما نراه على الإطلاق. فمن لونه الأسود الأساسي، يتحول القالب أولا إلى اللون الأحمر.
وبعدها إلى اللون الأبيض، لينتهي به الأمر إلى ما فوق البنفسجي، ليوحي القالب انه يقفز من موجة بطول محدد إلى أخرى وهكذا.
يتحدى ذلك الفيزياء الكلاسيكية. لحل هذه الأحجية، اضطر الفيزيائيون للاعتراف بأن الضوء يصدر على شكل جزيئات صغيرة من الطاقة هي الفوتونات.
لكل فوتون لونه المختلف. أما توالي الألوان بالنسبة لقالب الحديد فهو ناجم عن حقيقة أن بلوغ القالب لدرجة حرارة معينه، يجعله يتخذ ألوان الفوتونات التي تتناسب مع ذرة الحرارة المعطاة.
ولكن الفيزيائيون تأكدوا بأن الذرات أنفسها ليست كما كانت في مخيلتهم. بل على عكس اعتقادهم ليس للإلكترون مساحة ثابتة حول نواة الذرة.
فعلى سطح الشمس مثلا، تتفجر الذرات بعنف.
عند وقوع الانفجار ما ترسل الإلكترونات الذرة إلى مستوى ألى، لتعود بعدها إلى وضعيتها الأولية، فتبعث فوتونات من النور.
الأمر شبيه جدا، بصعود الإلكترون درجة إلى أعلى، ليهبط مرة أخرى، فيبعث كمية من الطاقة في كل مره.
يمكن للإلكترون أن يدور حول النواة متبعا اكثر من سير اتجاه واحد.
نهوضا في بحوثهم نحو خطوة أرقى، أكد العلماء انه لا يمكن إحصاء عدد خطوط الاتجاهات اللانهائية التي يمكن أن يتبعها الإلكترون.
بعبارة أخرى لا يمكن تحديد موقع ثابت للإلكترون في أي وقت كان، بل يمكن توقع احتمالات وجوده، في موقع ما. يمكن لهذه الاحتمالات أن تتمثل بطول موجة ضبابية، تطفو حول نواة الذرة.
بناءا على هذه الاكتشافات، يعتقد، أن الضوء يتألف من موجات، تتحول أيضا إلى تدفق للجزيئات. كما يبدو أن الإلكترون، على اعتبار انه جزيئات، يمتلك مزايا الموجات.
أدى هذا التعريف الجديد للضوء والمادة، إلى ثورة في التفكير العلمي. كان شائعا في الطبيعة حتى حينها أن الأسباب نفسها ستؤدي إلى النتائج ذاتها باستمرار.
فبتحديد الكرة التي يستهدفها مثلا، وبدفعها من الخلف بقوة محدده، يمكن لخبير في لعبة البليارد أن يسقط كرته في الحفرة. ولكن إذا أراد اللاعب القفز عن نظرية الكم، ستختلف النتائج بالكامل. من السهل تحديد موقع الكرة حين تكون ثابتة. أما أثناء دورانها فستكون مسألة تحديد موقعها محفوفة بالغيوم الضبابية بما يستحيل تحديدها.
والأسوأ من ذلك ، هو أن الكرة قد تسير في الاتجاه المعاكس تماما، لتحيد مثلا، 180 درجة عن الاتجاه المطلوب. حتى اللاعب القدير سيتعرض لاحتمال ان يخطئ الهدف المنشود.
من حظ اللاعبين، أن نظرية الكم تطبق في عالم الجزيئات الصغيرة جدا، وبنجاح كبير. تم بفضل نظرية الكم مثلا، اختراع ميكروسكوب يمكنه مراقبة الذرة بطريقة لم يسبق لها مثيل.
المبادئ التي اعتمد عليها الميكروسكوب النفقي بسيطة، هذا مسبار صغير يحمل على رأسه ذرة تظهر صورتها على السطح.
يتقرب الرأس من الأهداف التي تتم دراستها بدقة متناهية، بحيث يحتك سطح الذرة التي تخضع للدراسة بأسطح الذرات المحيطة بها.
حينها تمر شحنة كهربائية بينهما، وكلما قلت المسافة التي تفصل بين الذرة وما يحيط بها، تزداد كثافة الشحنة. بتصوير سطح الهدف المحدد يمكن أن نرسم خريطة دقيقة لسطحه.
تكشف الخريطة في بعض الأحيان عما لم يتمكن أي ميكروسكوب من استعراضه سابقا، وهي المواد التي تتركب منها كل ذره.
صحيح انه كان أحد مكتشفي نظرية الكم ، ولكن اينشتاين وجد نفسه على خلاف معها. فرغم قوله المأثور، إن السماء لا تلعب الزهر، إلا أن الصور السابقة تبرز نسبة عالية من المصادفات.
نظرية الصدمة الكبرى
لا يوجد نظرية علميه، غير قابلة للمناظرة هذه الأيام. على هذا الأساس وفي محاولة لشرح السؤال التاريخي المتعلق بأصول الكون، نشأت نظرية جديده، تعرف بالصدمة الكبرى. وقد بدأت مؤخرا تعتد بدعم كبير من قبل الأوساط العلمية .
من أين جئنا؟ انه سؤال طالما يطرحه الإنسان على نفسه. قد يقول الآباء لأبنائهم انهما جاءا بانصهار خليتين مع بعضهما البعض، هما البويضة والمني. ولكن علماء الأحياء يفضلون العودة إلى الكائنات الحية الأولى: البكتريا البسيطة.
أما علماء الفيزياء فقد غاصوا في أعماق الماضي السحيق. وبهذا شكلوا نظرية متكاملة ومتناسقة حول أصول الكون.
بناء على هذه النظرية، التي تسمى بالصدمة الكبرى، الكون لم يوجد منذ الأزل، أو على الأقل ليس بما هو عليه اليوم. قد يعود تاريخه إلى ما يقارب الخمسة عشر بليون سنه. بعد انفجار فريد.
بكثافته الهائلة، وحجمه الدقيق جدا، يمكن للانفجار أن يكون قد أدى إلى وجود الزمن والمساحة والمادة، والطاقة التي يتشكل منها عالمنا.
على سبيل إعادة بناء تلك اللحظة المدهشة لولادة الكون، تتعاضد المحاولات التي يبذلها علماء من مختلف القطاعات.
وقد عثر علماء النجوم على أول قطعة من الأحجية. سبق أن علموا ولعشرات السنين أن غالبية النجوم، كما هو حال كوكب الشمس لدينا، كانت جزءا من حشد واحد اسمه المجرة.
والمجرات ليست ثابتة في السماء.
من خلال معاينة ألوان إشعاعاتها تمكن الباحثون من التأكد بأن جميع المجرّات آخذة بالابتعاد عنا، وكلما أسهبت في الابتعاد، تزداد سرعتها في الرحيل أيضا.
أوصلهم هذا الاجتهاد إلى نتيجة مفادها، أن الكون يزداد اتساعا. تخيل الكون على شاكلة بالون، والكواكب نقاط، رسمت على جدرانه.
سوف نرى أن النقاط تبتعد عن بعضها البعض، حالما ينفجر البالون.
وان كنا على سطح إحدى هذه النقاط، سنرى أن باقي النقاط الأخرى آخذة في الابتعاد عنا. وسنرى الأبعد منها يتغيب بسرعة اكبر. هذا هو تحديدا ما يحصل في هذا الكون.
لماذا يزداد الكون اتساعا؟ كي نفهم ذلك، يجب ان نتخيله يسير نحو الخلف.
سنرى ان المجرات تتقارب من بعضها البعض لتجتمع في نهاية الأمر عند نقطة واحدة، فتتوحد كما كانت قبل خمسة عشر بليون سنه.
هذا ما جعل العلماء يعتقدون أن الكون بدأ من نقطة صغيره، بعد انفجار غريب. ولكن للتأكد من ذلك، تطلب الأمر مجموعة من الإثباتات الإضافية.
وردت إحدى الإثباتات الأكثر إقناعا باكتشاف قام به مهندسين كهربائيين عام 1964 في مختبرات بيل التلفونية. استعمل بينزياس وويلسون مستقبل موجات صامت لتحديد هوية التشويش السكوني الذي يؤثر سلبا على اتصالات الأقمار الصناعية.
قاما بمحض الصدفة، بالتنصت على ضجيج الكواكب الفضائية، القادم على ما يبدو من جميع الاتجاهات في الفضاء الخارجي. كانت الإشعاعات شبيهة بتلك التي ترد عن فرن كهربائي في المطبخ، ولكنها كانت اشد برودة.
يقول بينزياس وويلسون ان الإشعاعات يمكن أن تكون نوع من الصدى الناجم عن ذلك الانفجار الأولي.
تمكن العلماء من إعادة بناء الظروف التي كانت عليه الأمور عند ولادة الكون، والتي تعود نسبيا إلى جزيئات تسارعية. هذه الجزيئات تهجن المادة بالطاقة، لتمكن العلماء من التعرف على قدرة احتمال المادة، لدرجات الحرارة المرتفعة والضغط.
هذه التجربة، المدعمة بحسابات الفيزيائيين، تجعلنا نعتقد، أن الكون في البداية كان بالغ الصغر، وبالغ الكثافة، وبالغ السخونة معا.
فقاعات الصابون، تحتوي على الجزيئات البسيطة التي تتشكل منها المادة، كما وتلك التي يتشكل منها، الضوء.
ولكن الحرارة تبدأ بالهبوط، ثم تتوالى الأحداث بتسارع مدهش.
خلال جزء بسيط من الثانية، تتوافق لتشكل فوتونات ونيترونات.
وبعد دقيقتين لاحقتين، تتوافق الفوتونات والنيترونات بدورها، لتشكل فيما بينها الذرة. وبما أنها كانت مركزة للغاية، فإن المجموعة المجهرية كانت تأسر الضوء، لهذا كان الكون مجرد كتلة مبهمة.
وبعد مائة ألف عام من ولادته، أخذت حرارة الكون وكثافته تتدنى بشكل واضح، وبعد إفلاتها من اسر المادة، بدأت جزيئات الضوء تنتشر في الفضاء.
وهكذا تميز الكون بالشفافية، فلاشات الضوء الهائلة، التي أخمدت اليوم، هي أصول الإشعاعات التي تم اكتشافها من قبل بينسياس وويلسون.
تمكن قمر صناعي تابع لشركة ناسا مؤخرا من حل جزء آخر من الأحجية. وهو يكمن بتنوع بسيط في كثافة الضجيج الفضائي.
بالنسبة لفيزيائيي علم النجوم، يبدو أن هذا الاكتشاف يؤكد حقيقة أن الكون البدائي لم يكن متناسقا بل كان أشبه بمجمل الصابون.
من خلال تكاثف المادة وبفعل الجاذبية، نتجت المجرات عن هذا المجمل الفضائي.
كانت هذه نقطة البداية التي أدت إلى تشكيل الكواكب، والنجوم، وبعد فترة طويلة، نجمت عنها أشكال الحياة الذكية، القادرة على البحث، عن أسباب وجودها.
ربما أجابت الصدمة الكبرى على التساؤل الخاص بأصولنا. ولكن ما هو مصيره؟ يعتقد البعض أن الأمر سينتهي بأن يعود الكون صغيرا كما بدأ. ما قد يؤدي إلى انفجار هائل آخر. ينشئ بدوره كون جديد آخر.